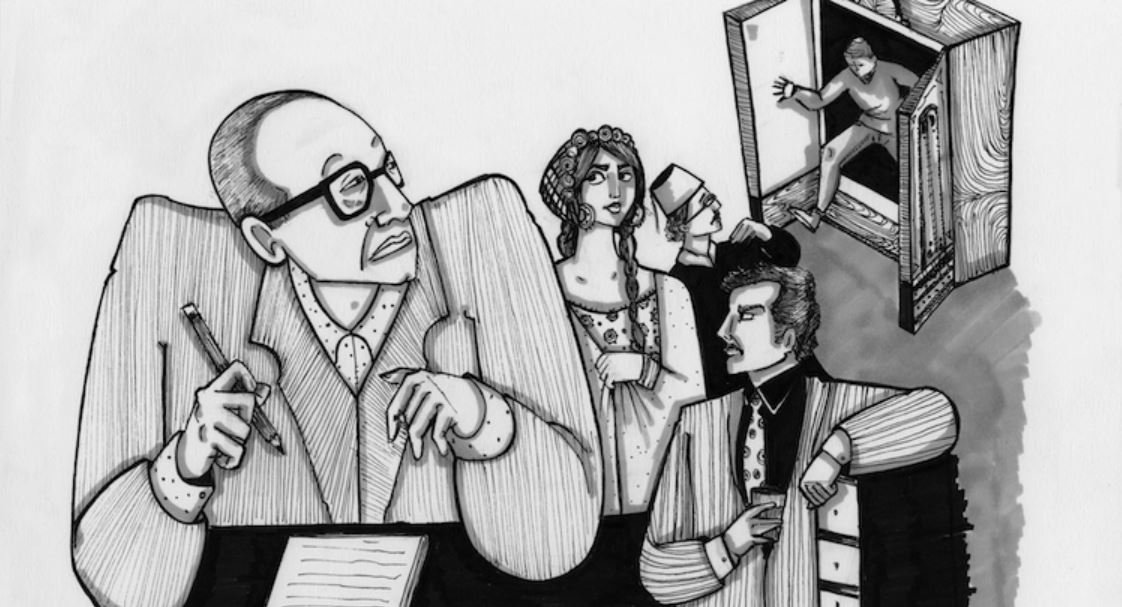
تصميم الرسم التوضيحي - ديمة نشاوي
الكل يعلن رأيه، حتى ما يتهجم به على الخالق، ولكنه لا يسعه إلا أن يكتم ما يضطرم في أعماق نفسه، وسيظل سراً مرعباً يتهدده، فهو كالمطارد، أو كالغريب، من الذي قسم البشر إلى طبيعي وشاذ؟ وكيف تكون الخصم والحكم في آن؟ ولِمَ نهزأ كثيراً بالتعساء؟
نجيب محفوظ، السكرية؛ (1957)
في الثاني والعشرين من شهر أيلول من عام 2017، أقامت فرقة مشروع ليلى اللبنانية حفلاً موسيقياً في أحد المراكز التجارية في القاهرة. ومن ضمن ما تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي من توثيق للحفل، كانت هناك بعض الصور والفيديوهات لشباب يرفعون علم الرينبو (قوس قزح)، أحد رموز التنوع والاختلاف الجنسي. وخلال الأيام القليلة اللاحقة تصاعدت وتيرة حملة أمنية على مجتمع الميم في مصر.
ورغم أن التنكيل الأمني لم يكن أمراً جديداً على أفراد هذا المجتمع، إلا أن حِدّة السعار الإعلامي، وحالة التحريض الواسعة التي صاحبت واقعة رفع العلم، والعدد النهائي للمقبوض عليهم (75 شخصاً) والماثلين أمام المحاكم كان غير مسبوق. لم يحدث شيء مشابه منذ واقعة الكوين بوت الشهيرة في عام 2001، والتي أسفرت عن القبض على 52 شخصاً من مرتادي الملهي الليلي -الذي سُمّيت القضية باسمه- ومحاكمتهم بتهم مختلفة، أشهرها «اعتياد ممارسة الفجور» و«ازدراء الأديان».
ورغم فداحة الحادثتين وما صاحبهما من تحريض أمني ومجتمعي ضد متنوّعي الهوية الجنسية في مصر، إلا أنهما لم تسفرا عن أي تحوّل (تغيير) حقيقي أو ملموس في تعامل الدولة والمجتمع مع مجموعات المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات، بل تمت إعادة إنتاج الخطاب نفسه، الذي استُخدم لتبرير التنكيل والعنف. ورغم حصول إدانات دولية وضغوطات من عدة جهات وحكومات غربية، إلا أن النظام لم يغير شيئاً من منهجه في التعامل مع مجتمع الميم كفصيل مهمش، يمكن التنكيل به واستخدامه كذريعة لخلق حالة من «الفزع الأخلاقي»، للتشويش على فشل النظام على جميع الأصعدة وتراجع شعبيته، في سلوكٍ يمكننا تسميته «سياسات الإلهاء»، التي تلجأ إليها النظم السلطوية عموماً، والنظام المصري بشكل خاص.
بالأخص، فإن مخاوفي مُركّزة على غياب إطار [مفاهيمي] في الوقت الحالي، الذي يمكن من خلاله البحث عن أصل أو تطور الهوية الفردية المثلية، دون أن يكون إطارٌ كهذا مبنياً، بشكل ضمني، على مشروع أو هوس غربي متجاوز للفرد، يتمثل في محو تلك الهوية.
إيف كوسوفسكي سدجويك، عن معرفة الخزانة؛ (1990)
إيف كوسوفسكي سدجويك (1950-2009) هي إحدى مؤسِسات ورائدات النظرية الكويرية في النقد والتحليل. تقوم النظرية الكويرية على عدد من الروافد النقدية والفلسفية داخل الأكاديمية الغربية، وقد ظهرت منذ منتصف السبعينات متأثرة بفلسفة ما بعد البنيوية والتفكيكية، بالتوازي مع الحركات النسوية وتياراتها الفكرية المختلفة، وحركات الطلبة والتي تضمنت حراكاً وتنظيراً حول الهوية المثلية وحقوق المثليين وتعتبر سدجويك من الجيل الذي عاصر الحركة الطلابية في الستينات والموجة الثانية من الحركة النسوية، خاصة في سياق تغيير السياسات التعليمية لمعظم الجامعات، التي بدأت منذ نهاية الستينات بالسماح للنساء بدخول الجامعة بشكل أكبر، وفي أقسام أكثر تنوعاً، وتقلد المناصب التعليمية بمعدلات أكبر من ذي قبل، أسوة بالرجال. وبدأت سدجويك بالإسهام في الكتابات النقدية عندما نشرت نسخة منقحة من رسالة الدكتوراة الخاصة بها في 1981 بعنوان، الشخوص وراء الحجاب: تصوير المظهر في الرواية القوطية، لتُتبعها بأول دراسة نقدية عن رهاب المثلية كمنظور لقراءة الأدب الفيكتوري في رهاب المثلية، ازدراء النساء، ورأس المال: مثال «صديقنا المشترك» (الرواية الأخيرة لتشارلز ديكنز) (1983)، وبذلك تتكون النواة الأولي لعمل سدجويك النقدي. وبحلول عام 1985 أصدرت سدجويك كتابها الأول ما بين الرجال: الأدب الإنجليزي ورغبات الذكور المثلية-الاجتماعية، لتصبح من مؤسِسات تيار نظري يستخدم الأدب كساحة لقراءة نزعات رهاب المثلية وتتبع تاريخها كجزء من وجهات نظر ومواقف تباينت ما بين تشريح الجنسانية وتكثيف الخطاب العلمي الذي يحللها كسبيل للمعرفة (فوكو وأتباعه)، من جهة؛ وخلق جنسانية مهيمنة، من جهة أخرى، غيرية بالأساس تخضع للسلطة الحداثية، مرتبطة بشكل أساسي بتطور هذه السلطة (الدولة القومية)، وبتطور النظام الأبوي الرأسمالي (إسهامات الحركات النسوية وتنظيراتها). .
وخلال تلك المسيرة الأكاديمية، كتبت أيف كوسوفسكي سدجويك كتابها، عن معرفة الخزانة (1990)، وهو من أهم ما كتبت، ويشكّل امتداداً لذلك المشروع النقدي حول تطور خطاب فكري/فلسفي في الغرب منذ القرن الثامن عشر، ظل محوره محو أو إبادة الهوية المثلية، على اختلاف تجلياتها وطرق تعريفها أو توصيفها.
وتجدر الإشارة إلى أن السياق التاريخي لكتابة عن معرفة الخزانة هو أحد أسوأ الكوارث الصحية التي اجتاحت العالم المعاصر، ألا وهو الانتشار الوبائي لمتلازمة نقص المناعة في الولايات المتحدة في مطلع الثمانينات. لم يسبق أن تمت مناقشة مرض في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى ظهور نقص المناعة المكتسب. لم يُعرف سبب المرض، ولم يستنبط متخصصو الفيروسات تسميةً للمرض حتى عام 1987، أي بعد خمس سنوات من بداية ظهوره بشكل وبائي.
لا يمكننا، كعرب لم نشهد تلك المأساة في سياقنا، أن نتخيل وقعها على جيل سدجويك ومجتمع الميم في ذلك الوقت، لكن يكفي أن نعلم أن أكثر من نصف المصابين به قد توفوا خلال السنوات الثمانية الأولى من ظهوره، وأن إدارة ريغان رفضت الاعتراف بخطورة المرض، بل سخرت منه وتجاهلته لمدة ستّ سنوات، حتى 1987، أي بعد وفاة أكثر من 23000 مصاب، كان من الممكن جداً تفادي موتهم بانتهاج سياسات صحية ومجتمعية أكثر عملية وواقعية.
أنتج هذا السياق خطابات عدة، تراوحت ما بين استخدام نظريات الاصطفاء الطبيعي، التي تفسّر المرض باعتباره ردّ فعل الطبيعة للقضاء على المثليين (وكأن الطبيعة ذات واعية، لها فعالية أخلاقية تحاسب البشر بموجبها)، وبين خطاب لجأ إلى الدين لتبرير الهلاك الذي حلّ بالمنحلين كما حلّ الهلاك بمدن سدوم وعمورة، وخطاب ثالث برر انتشار المرض بين المثليين كمرحلة أخيرة وحتمية لتدهور وانحلال الحضارة الغربية.
لا يمكننا إذا لوم سدجويك إذا كان جلّ تنظيرها متمحوراً حول محاولة الرد على تلك الخطابات اللا-إنسانية، والتصور الرئيسي الذي يقبع خلفها: فكرة الإبادة كنتيجة حتمية لوجود المثليين. ولذا يمكننا أن نتسامح مع شطحات سيدجويك التفكيكية، ومع تحليلاتها التي قد لا تعطي موقفاً واضحاً، وتفضل أن تتكلم عن «تناقضات منتجة» بدلاً من التكلم عن مشروع تحرري أو تصور يتجاوز لفت النظر إلى تلك التنتقضات بتجلياتها المختلفة رغم انخراط سدجويك في العمل السياسي والنسوي منذ التحاقها بالجامعة في 1967، إلا أنها لم تكتب أو تنظّر عن العمل السياسي بشكل مباشر، ولم تتمحور كتاباتها حول مشروع سياسي واضح، إذ تركزت معظم أعمالها حول الأدب والنقد بشكل كبير. .
لا يعني غياب سردية «وباء الإيدز» عن العالم العربي ومخيلته بالضرورة غياب خطابات مشابهة نتيجةً لعوامل مركبة ومعقدة عديدة، لم ينتشر مرض متلازمة المناعة بالشكل الوبائي نفسه في معظم العالم العربي مثلما حدث في الولايات المتحدة في الثمانينات، على سبيل المثال. غياب «سردية الوباء» لا يعني أنه لم أو لا توجد حالات إصابة، بل العكس: المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة تقريباً التي ما زالت تشهد ازدياداً في نسب الإصابة بالمرض حالياً. كما أن عدم انتشاره بشكل وبائي في الثمانينات لا يعني أيضاً عدم وجود تمييز شديد القسوة والعنف ضد مرضى متلازمة المناعة في العالم العربي، لكن ذلك التمييز، رغم شروره، لم ينتج حراكاً سياسياً واسعاً، أو تعبئة مجتمعية على غرار دولٍ أخرى.، بشكل مدهش، لما أنتجته ماكينة سياسة المحافظين في الولايات المتحدة. لقد خلقت حالة الوباء والهلع، وعدّاد الموت الذي تجاوز الآلاف في أقل من بضع سنوات حالة استثنائية فرضت على مجتمع الميم التحرك بسرعة وإيجاد وسائل لمواجهة ذلك الوضع السياسي المميت، المميت حرفياً. ورغم اختلاف السياق، فإن ما حدث في العالم العربي هو إنتاج خطابات مشابهة (أخلاقية، قانونية، دينية،…إلخ) معادية للمثلية رغم غياب تلك الحالة الاستثنائية للوباء. إن تنكيل النظام المصري بمجتمع الميم يُعدّ الأسوأ من نوعه في تاريخ نظام يوليو، وربما في تاريخ الدولة الحديثةلاشك أنه لدى نظام يوليو تاريخ طويل وحافل في التنكيل بالفصائل السياسية المعارضة، من الشيوعيين واليسار إلى الإخوان المسلميين وأتباعهم. لكن الملاحقة الأمنية لمعارض سياسي لا تتساوى إطلاقاً مع التنكيل بإنسان نتيجة لاختيارات/ها الجنسية والحميمية، فلا يوجد جوهر إيدولوجي معارض للنظام فيما يخص الاختيارات الحميمة (هناك بالطبع قراءة فوكو للجنسانية كمساحة لتكثيف حضور السلطة وسيطرتها على أجساد البشر في سياق الدولة القومية الحديثة، ولكن فوكو نفسه لا يقول أن هناك جوهراً إيدولوجياً للاختيارات الجنسانية. يوجد هوس معرفي لاستنطاق الأجساد والنفوس، ولكن لا يوجد جوهر إيدولوجي له تطلعات سياسية أو تصورات ميتافيزيقية عن السلطة). بالطبع هناك تسييس للاختلاف من قبل النشطاء الكويريين، ولكن مثل هذا التسييس مرتبط بالأساس بكسر أنماط السلطة المعنوية والمادية للنظام الأبوي-الرأسمالي، وفي نهاية الأمر لا يمكننا اعتبار جميع المثليين كويريين، أو فرض تلك القراءة الإيدولوجية عليهم.. لم تشهد مصر مثل تلك الحملات الممنهجة لترصّد مجتمع الميم والنيل منهم كما يحدث الآن، ولم تُسخِّر الدولة كل أجهزتها الإعلامية لخلق حالة من «الفزع الأخلاقي» بهذا الشكل من قبل. هل يمكننا أن نقرأ «لحظة التنكيل» في ظل سردية «لحظة الوباء»؟ ربما. إن استمرار وجود مجتمع الميم في ظل السياق السياسي الحالي بات، بالفعل، على المحك، فأمن وسلامة أفراده مهددة في ظل نظام تتصاعد فيه وتيرة جنون السلطوية، ولا يبدو في الأفق أي تراجع لهذا الغشم و التجبر. يفرض علينا مثل هذا الوضع، كما فرض على سيدجويك وجيلها، أن نخرج من «الخزانة» ونفكك الخطابات التي تحيق بمجتمع الميم، فنكشف عوار وتناقض منطقها، ونؤكد على أن النظم السياسية العربية هي نظم سلطوية بالأساس، لا تبالي بأي فصيل تذبح طالما وفّر لها ذلك الفرصة لترسيخ المحافظة الأخلاقية، بما يسمح للمجتمع المحافظ أن يتماهى مع السلطة في لحظة خاطفة من الشعور بالقدرة على الفعل السياسي (أو بمعنى أصح ممارسة السلطة) ضمن الهوامش التي تقررها السلطة نفسها، حتى لو كان ذلك على رقاب الآخرين.
ولأن كل الكتابات النقدية عن مجتمع الميم بالعربية لاتزال بالنذر اليسير (وجاء أغلبها من مواقع موالية للنظام وخطابه)، وما كتب بالإنجليزية مغرق أكثره بالاستشراق، أو -فيما هو أسوأ- ادّعاء أن المثلية هوية تم استيرادها من الغرب بتواطؤ من المجتمع المدني؛ وقلة هي التي حاولت الكتابة بشكل نقدي (مثل فريديريك لاجرنج، الذي أدين له بالكثير في كتابة هذا النص)، فإن محاولة قراءة الخطاب الذي تم إنتاجه في المخيلة العربية الحديثة (خاصة الأدب) على غرار كتاب سيدجويك، يصبح فعل ملحاً، إن لم يكن أمراً لا مفر منه. وليس ذلك للوصول إلى النتائج نفسها أو تقديم التحليل نفسه، إنما لفتح مساحة للجدل والنقاش، تتجاوز الاستشراق أو إنكار الذات بشكل ساذج وطفولي. كيف يمكننا الدفاع عن وجودنا إذا كانت الإبادة هي مصيرنا المحتوم، أو الخزانة هي سكننا المفترض؟
بادىء ذي البدء، أو البديهيات كما تقول سيدجويك
لست من هواة الكتابة الأكاديمية، ولا ينوي هذا النص أن يكون نصاً أكاديمياً (فهو يستعير بعضاً من منهاج سيدجويك في التفكيك والنقد، ويبقي في الوقت عينه على التشذر كشكل أساسي). ولكي أتفادى بعض الاعتراضات التي قد تقام على القراءة التحليلية التي سأقدمها تالياً، سأحاول تلخيص بعض أهم تلك الإشكاليات مُحتملة الورود، والرد عليها أولاً.
1- أين المثليات؟
إن محاولة استلهام التفكيك كمنهج لقراءة عدد من النصوص العربية التي تركز على المثليين، وعلى التصورات الأدبية أو المتخيلة عنهم، هي اختيار واضح، إن لم يكن مقصوداً بشكل حتمي. ويفرض ذلك الاختيار السؤال: «أين المثليات من تلك التصورات أو السرديات؟».
أعترف أن جُلّ همي وتركيزي انصبّ على محاولة الربط بين ما حدث من تنكيل وملاحقات أمنية في الأعوام الأخيرة، وتاريخ ذلك الخطاب الإبادي وترسّخه في المخيلة العربية، الخطاب الذي انصبّ تركيزه على الرجال المثليين والمتحولات جنسياً (الترانس)، ولم يكن هذا بقصد تهميش المثليات أو التغاضي عمّا يلاقينه من تهميش وتعامي.
نتيجة مجموعة من الأسباب -التي سأحاول تناولها بسرعة واختصار- فإن ثمة عوامل معيقة للحديث عن سرديات وتجارب المثليات، وبعض هذه العوامل سياسي-اجتماعي، فيما بعضها عملي/واقعي. فعلى سبيل المثال، كانت المثليات تاريخياً أقل عرضة للملاحقة الأمنية أو التنكيل من قبل أجهزة الدولة العقابية. ولم يكن ذلك من باب التسامح أو الاعتراف بجنسانية النساء واختياراتهن، ولكن لاعتقاد سائد أن أجساد النساء ورغباتهن تحتل حيز الخاص/الحميمي، الذي نادراً ما يستدعي التساؤل أو التحري الأمني، وهو الحيز الذي دائماً ما يثير الشكوك بالنسبة للمثليين من الرجال. أيضاً، نجد أن جنسانية النساء تصبح فاعلة أو مؤثرة فقط عندما تموضع نفسها في مجال رغبة الرجال، ووفقاً لهذا المنطق فإن اشتهاء النساء للنساء لا يستدعي الجزع أو القلق الذي يثيره اشتهاء الرجال للرجال، فرغبات النساء وفاعليتهن غير مرئية وغير مؤثرة إذا لم يكن محورها هو الرجل وجسده.
العامل الثالث هو اقتناع كثيرين أن المثليات لسنَ إلا نساء ضللن طريقهن إلى الرغبة. ولأن جنسانية المرأة ودورها في المخيلة العربية/الإسلامية لا يتعدى «استقبال» أو «احتواء» رغبة الرجل، تصبح مثلية النساء عرضاً عابراً، غير مُجدٍ ولامؤثر (هل لأنه، طبقاً لهذا التصور، هو جماع بلا إيلاج؟ ودون خطورة الحمل والإنجاب؟ فهو، إذن، لا يرقى إلى مرتبة الزنا؟بإجماع أغلب المذاهب فإنه ليس لـ«السحاق» حدّ، ولكن يستوجب التعزير حسب ما يقدّره القاضي، وغالباً ما تواتر في الفقه الإسلامي أن «علاج السحاق» هو تزويج النساء وضمان توفير الأزواج الصالحين من الرجال. ويمكن «معالجته» بالزواج من الرجل المناسب حسب التصور الشائع لدى المجتمع العربي/المسلم.)
لا يحاول القصور المُحتوى في هذه القراءة ترسيخ التعامي عن تجارب المثليات، لكنه مجرد تجربة لاستخدام منهج التحليل الذي طورته سيدجويك، تجربة آمل أن تُرى أيضاً كدعوة للعمل على قراءة موازية لنصوص تناولت تجارب المثليات.
2- هناك انحياز نسوي واضح
رغم غياب سرديات المثليات في هذه القراءة، وعدم التركيز بالأساس على تجارب الغيريين من الرجال والنساء، إلا أن هذه القراءة محكومة بانحيازات نسوية أساسية. وأعني بـ «انحيازات نسوية» مجمل الأعمال النظرية التي اتخذت من موقع النساء في المجتمع، بوصفهنَّ فصيلاً تم سلب أو قمع أو تهميش فاعليته بسبب نوعه الاجتماعي، الذي يفرض على النساء دوراً محدداً وسردية محددة (على سبيل المثال لا الحصر، النساء كمستودع الشرف؛ النساء كوعاء الأبناء والنسل والقائمات على مهمة الإنجاب والتربية؛ النساء كأجساد خلقت لمتعة الرجل ورغباته،…إلخ). إن نقد الأبوية والذكورية الذي أنتجته النساء على مر قرنين من الزمان هو جزء لا يتجزأ من تاريخ نضال المثليين ونقدهم، هم كذلك، للمجتمع الحداثي بشكله الرأسمالي-الأبوي الذي نعرفه. ولا يمكننا فهم حالة الهلع والتقزز التي تصيب الكثير من الرجال عند مشاهدة المتحولات جنسياً في العالم العربي دون الرجوع إلى نقد النسويات للذكورية وما يكشفه ذلك عن احتقار أو رفض لكل ما هو «أنثوي»/«نسائي» كمقابل موضوعي لما هو «ذكوري»/«رجولي»، كما لا يمكننا أن نفهم ذلك الرعب الذي ينتاب الكثيرين بناءاً على معتقدهم بأن المثلية أو المثليين هما نهاية الجنس البشري دون الرجوع إلى النقد النسوي للأبوية بوصفها التصور الأوحد للاجتماع البشري في صورة أسرة يترأسها أب، ذكر، غيري، منجب، وتشمل أماً وأولاداً من نسل ذلك الذكر. ذلك النقد العميق للأبوية، وما تفرضه من تصورات أحادية للشكل الاجتماعي المقبول والمتوقع من الجميع، ندين به جميعاً للنسويات والنسوية
بطبيعة الحال، هناك حاجة وضرورة لإعادة قراءة النص الديني وما تواتره الفقهاء والمحدثين، وأخذ تاريخانية تلك الأحكام بعين الاعتبار، والتساؤل عن هذا «التساهل» العجيب مع غياب حجة أو نص والإيمان المطلق بحتمية الموت/الإبادة خاصة فيما يخص المثلية. ولكن مثل ذلك البحث أو النقد يتجاوز هدف هذه القراءة، فمثلما فعل معظم الأدباء العرب عند تناولهم المثلية، خاصة نجيب محفوظ، وكتبوا من موقع «حداثي» بكل ما يعنيه «حداثي» من تجاوز إطلاق النص الديني ومركزيته وخلق مساحة من التردد (وهذا ليس تجاوزاً كاملاً بالطبع)، فإن هذه القراءة تحاول الاشتباك مع تلك النصوص من الموضع نفسه.
3- أين الدين من كل هذا؟
مَن منا لم يجد إشارة أو حتى سرداً طويلاً عن قصة قوم لوط في أي إشارة من قريب أو من بعيد للمثليين باللغة العربية؟ ليس هذا فقط استدعاءً للسلطة الأخلاقية والسياسة للنص، ولكنه أيضاً تاريخ طويل من التأصيل الفقهي لموقف الدين من المثليين. وهو موقف مأزوم تماماً مثل توصيفه، فحتى التوصيف «اللواط» توصيف إشكالي إلى حدّ كبير، يعكس تلك العلاقة المأزومة، فكأن المسلمين الأوائل فقدوا منطق اللغة حين «واجهوا» المثلية، فنسبوا فعلاَ «شديد الفحش» -كما يصفه الفقهاء- لـنبي معصوم» (ولو كنت من هواة التلاعب باللغة لبدأت حركة تدعو إلى إعادة تأهيل لفظ «اللواط» كسنة حميدة تنسب إلى نبي) بالمقارنة بالتراث اليهودي-المسيحي، نجد أن الأوقع أن الفعل يُنسب إلى أصحابه، فـ «لواط» كانت دائما ما يشار إليها بلفظ «سدومية»، نسبةً إلى المكان وليس الشخص. . ورغم غياب أي حكم واضح في النص القرآني لـ «جريمة اللواط» (قارن مع حدود الزنا أو الحرابة أو السرقة، على سبيل المثال) فإن إدانة قوم لوط وما فعلوه (سواء كانت المثلية أو غيرها) في النص القرأني، لا شكَّ فيهاذُكر قوم لوط في القرآن في ثمانية مواضع مختلفة: في سور الأعراف: الآيات 80-84، هود :الآيات 69-83، الحجر :الآيات 58-78، الأنبياء: الآيات 71-75، الشعراء: الآيات 160- 175، النمل: الآيات 54-59، العنكبوت: الآيات 28- 35، القمر:الآيات 33-39. ولا يكاد يخلو موضع ذكر دون إدانة أو استنكار لأفعالهم، تارة جملة ودون تخصيص، وتارة أخرى بتفصيل منكر ما فعلوه.. ورغم غياب أي إجماع على حكم أقره النبي عند معظم الفقهاء، إلا أن ما جاء على لسان الصحابة والتابعين فيه شبه إجماع على الموت كعقوبة ملائمة للفعل، وتبعتهم في ذلك أغلب المذاهب (فيما عدا أبو حنيفة وما تأخر من فقه الشافعي) واختلفوا في طريقة القتل. هناك جدل في المباحث الفقهية عن صحة ما ورد عن النبي والصحابة في حكم اللواط (فتم استبعاد أغلب الأحاديث، على سبيل المثال، لضعف إسنادها). ولكن إجماع الفقهاء وأهل الرأي على تجريم الفعل، وخاصة الفقهاء اللاحقين، يكاد يتجاوز أي مُساءلة حقيقية لأدلة تحديد العقاب، والتركيز بشكل كامل على ضرورة العقاب في حد ذاته.
وتظهر نزعة «الإبادة» كـ«حل نهائي للمثليين» عندما نقارن بين عدم استدعاء الدين أو سلطته الأخلاقية في كثير من تصويرات العلاقات الغيرية عند الأدباء العرب، في حين تظهر -وياللعجب- حتمية الموت» لأنه «شرع الله» عند الحديث عن المثليين (والذي يختفي في العلاقات الغيرية خارج نطاق الزواج على سبيل المثال، فيمكن تجاوز الإطار الأخلاقي للنص عند تصور العلاقات الغيرية، لكن لا مفرّ منه عند تناول المثلية).
4- التفكيك ليس نهاية الطريق
كتبت سيدجويك في عن معرفة الخزانة عن استخدامها للتفكيك كمنهج لمحاولة قراءة تراكم تاريخي، أرتأته هي بما يعكس على واقعها في الولايات المتحدة في الثمانينات. وأرى، بشكل شخصي، أن تلك القراءة كانت مفيدة ومنتجة لتحليل يُمكّننا كقراء عرب أن نشتبك معه في سياقنا الحالي. ولكن لا يمكن اعتبار التفكيك -بحدّ ذاته- أكثر من مجرد أداة أو «عدسة» ، للتحليل أو النقد. إذ أنني لا أعترف بالتفكيك كـ «غاية» في حد ذاته، ولا أرى أنه مفيد كإطار نهائي، مطلق، لفهم العالم. فاستعارتي لمنهج سيدجويك، أو استخدامي لتحليلها، هو استخدام نفعي/براغماتي بالأساس، لأني ما زالت أؤمن بضرورة التفكير في سردية تفسر لنا الظواهر المحيطة بنا. وأدرك مدى سذاجة مثل ذلك الموقف، الذي قد يرى البعض أن الزمان قد عفا عنه (فلقد انتهى زمن السرديات الكبرى، كما يحلو لكثيرين القول). ولكن التفكيك، في حد ذاته، كنقطة في مسار تاريخي معين، مرتبط بمقاربات ما بعد الحداثة، هو منهج أو أداة تحليلية تفتقر إلى موقف واضح من السؤال: «وماذا يمكننا أن نفعله الآن؟»
قصص لا زلنا نرددها
ورفع الشيخ درويش رأسه بغتة وقال دون أن يلتفت نحو المعلم:
يا معلم، إمرأتك قوية، فيها من الرجولة ما يعوز الكثيرين من الرجال، وهي ذكر وليست بأنثى، فلماذا لا تحبها؟
وصوب المعلم نحوه عينين ناريتين وصاح في وجهه:
اقطع لسانك!
وصاح أكثر من واحد من الجالسين:
حتى الشيخ درويش!
وولاه المعلم ظهره صامتا، وراح الشيخ درويش يقول:
هذا شرّ قديم، يسمونه في الإنجليزية homosexuality وتهجئتها h o m o s e x u a l i t y ولكنه ليس بالحب.
نجيب محفوظ، زقاق المدق؛ (1947)
يطالعنا من ذلك المقتبس أول تناول لمصطلح المثلية بمعناه الحديث، Homosexuality، كما صاغه الكاتب كارل ماريا كارتبيني في 1868، في رواية عربية. ويستخدم محفوظ المصطلح نفسه، ولكن من موقع متناقض لكارتبيني (الذي كان يحاول دفع بعض من الظلم الواقع على المثليين من وصم اجتماعي وعقوبات جنائية بمقتضى القوانين المنتشرة في ذلك الحين).
تدفعنا محاولة استخدام منهج سدجويك في السياق العربي للنظر إلى ما أنتجه الأدب العربي الحديث من تصورات وتناولات للمثلية. وكما يشير المقتبس، فإن أول ما يظهر لنا من ذلك الأدب، هو روايات نجيب محفوظ. لم ينجُ أحدٌ من تأثير محفوظ فيما أنتجه وصاغه من تصورات عن المثلية والمثليين. ولعل ما بدأه محفوظ في أربعينات القرن الماضي مستمر معنا إلى الآن، يجتره الأدباء المصريّون، عقداً بعد عقد، قصة وراء قصة.ذلك الخطاب الذي تشوبه علل الحداثة من خلق أنساق اجتماعية جديدة وإعادة تعريف السلطة في شكل الدولة الحديثة من ناحية، واستمرار الكثير من أنساق وقيم ما-قبل حداثية في حالة من التوتر الدائم مع ما غيّرته الحداثة (على سبيل المثال لا الحصر، الحضر/التمدن وما خلقه من كسر لأنساق علاقات اجتماعية تقليدية أعادت تعريف الفراغ/المساحة العامة والحميمية؛ إعادة توزيع الأدوار الاجتماعية بشكل مختلف خاصة فيما يخص من تعليم النساء ودخولهم لسوق العمل،…إلخ).
ولست بصدد دراسة نقدية لأدب نجيب محفوظ، فهذا يتجاوز الهدف من هذه القراءة. لكن، كما فعلت سيدجويك، أحاول تتبع تلك المسارات الأدبية التي أنتجها محفوظ، لأنها جاءت معبرة تماماً عن مخيلة المصريين ومواقفهم الأخلاقية والمعرفية من المثلية، مخيلات ومواقف ذات إشكاليات شديدة التعقيد والخطورة، ذلك أن أغلبها يسفر عن قتل أو إبادة المثليين كما أشرت من قبل، ولكن، في الوقت نفسه، يحتم وجودهم حتى يستطيع الجميع «النأي» بنفسه عن مثل هذا «الشر القديم» كما أسماه محفوظ.
تقول سدجويك إن التعريف الحداثي للغيرية كهوية مختلقة، يتطلب تحديد مسار واضح لرغبات الرجال، خاضع لسلطة الدولة والنظام الرأسمالي، من خلال مؤسسة الزواج والأسرة ويصبح ذلك المسار هو الشكل المقبول، الذي يجب على الجميع سلوكه. وبالتوازي، يتم خلق تعريفات وتشريحات (في لغة فوكو) نفسية واجتماعية جديدة لما يجب على الجميع تجنبه: المثلية. فحتى بدون وجود قانون يجرم المثلية، يصبح الهلع والرهاب من المثلية قوة ضبط وتنظيم للعلاقات الحميمية وحدودها المقبولة.
ولأن محفوظ من القلائل في جيله الذي كتب عن شخصيات مثلية وطور موقفاً وتصورات واضحة منها قارن مع موقف طه حسين على سبيل المثال، والذي أشار إلى المثلية في سيرته الأيام مستخدماً المصطلح التقليدي «نواسي الهوى» (الأيام، الجزء الثالث،231)، بالإشار إلى الشاعر أبي النواس. ورغم السخرية الكامنة في مثل هذا المصطلح، إلا أنه لا يخلو من رقة وشاعرية ما، لم يستخدمها محفوظ أو غيره على الإطلاق.، -اختلفت في مدى تعقيدها من رواية إلى أخرى- فإن كثيرين من بعده نقلوا عنه، وظلت المصطلحات والأفكار التي كتبها محفوظ راهنة، يُعاد استنساخها إلى الآن. وعند قراءة النصوص وتفكيكها، تظهر لنا تلك الأفكار والمسارات بوضوح، ويصبح من السهل علينا ربط تلك المسارات والأفكار بالخطابات التي يتم تداولها في سياقنا المعاصر، بدءاً من مثقفي الدولة وانتهاءً بالمؤسسات القضائية والعقابية.
سيماهم على وجوههم أو هم لا يبصرون
فرأى المعلم كرشة، بجسمه الطويل النحيل، ووجهه الضارب للسواد، وعينيه المظلمتين النائمتين» «كان السيد رضوان الحسيني ذا طلعة مهيبة، تمتد طولاً وعرضاً، وتنطوي عباءته الفضفاضة السوداء على جسم ضخم، يلوح منه وجه كبير أبيض مشرب بحمرة، ذو لحية صهباء، يتسع النور من غرة جبينه، وتقطر صفحته بهاء وسماحة وإيماناً».
نجيب محفوظ، زقاق المدق؛ ص 9،10
يتجاوز تباين شخصية المعلم حسين كرشة والسيد رضوان الحسيني في رواية زقاق المدق مجرد التباين في الشكل والهيئة. استخدم محفوظ كرشة كنقيض حسي ومعنوي للسيد رضوان: أبيض/ضارب للسواد؛ يتسع النور من غرة جبينه/عيناه مظلمتين النائمتين… أينما جمع السياق كرشة مع السيد رضوان استغل محفوظ ذلك التناقض والتنافر لأقصى درجة.
ورغم أن الجميع مذنبون في عالم محفوظ، فلا يوجد هناك أبرياء، إلا أن كرشة يحظى بنصيب الأسد في نعته بالشر والقبح، لا ينافسه في ذلك إلا حميدة (يصفها محفوظ على لسان أحد أبطاله «أنها عاهرة بالفطرة»).
يصبح وجود كرشة في هذا التكوين ضرورياً حتى يظهر نقاء وصلاح السيد رضوان، فلا يمكننا أن نرى ذلك التفرد بالسماحة والإيمان دون وجود ذلك السواد والشر الذي يمثله، بل يجسده كرشة بوجهه وعينيه وجسده النحيل الآثم. ويقر محفوظ أول مسار في تعريف الشخص المثلي، فهو دائماً في تناقض مع من حوله، إن لم يكن بفعله، فبوجهه وعينيه وجسده.
يربط محفوظ بين اختيارات كرشة وانعكاس ذلك بشكل مادي عليه، دون استعارة لغة دينية مباشرة ولكن بربط الفعل بحكم أخلاقي غاية في الوضوح. ويستمر محفوظ في استخدام كناية «العين» وما ترى وما تعكسه من خبايا النفس، ويظهر ذلك الحكم الأخلاقي مرة أخرى حين ينبعث النور من عيني كرشة عندما ينظر إلى شاب أثار إعجابه: «وانبعث من عينيه المنطفئتين نور خافت شرير وراح يرنو منه بفيه الفاغر وشفته المتدلية» (ص 51).
يرسّخ خلق مثل هذا التصور الذي يربط بين مثلية شخص وسمات وجهه وجسده (في مقاربة لأفكار الداروينية الاجتماعية وما خلفته من إرث عنصري وإشكالي)، الاعتقادَ بإمكانية التعرف على المثلي بـ«مجرد النظر إلى وجهه»، وكأن للمثلية دلالات جسدية تعكس ذلك التصور المعنوي الذي رسمه محفوظ. ويتكرر ذلك التصور عن «سيمات المثلي» بعد خمسة عقود من محفوظ، فيكتب علاء الأسواني عن «ذلك الاربداد الغامض الكريه البائس الذي يغلف دائما وجوه الشواذ» (عمارة يعقويان، ص 56).
من ناحية أخرى، نجد ما تسميه سيدجويك بـ «التبادل البصري المنقوص»، فنحن نرى المثلي (نرى السواد، العينين المظلمتين، الوجه المشرب بالسواد… إلخ) ونرى مثليته كذلك؛ في حين أن المثلي، طبقاً لمحفوظ، دائماً ما تفتقد رؤياه لكل الواقع/الحقيقة. فرؤية المثلي «ناقصة»، «غير مكتملة» (حتى في ملحمة الحرافيش قال محفوظ عن الفتوة «وحيد» أن رجاله «دعوه سراً بالأعور»..مرة أخرى للإشارة إلى الرؤية المنقوصة أو المشوهة)، تعكس بذلك الشر أو الشذوذ، فبغياب الرؤية الكاملة للواقع ينفصل المثلي عن السرب، ويصبح متقوقعاً حول مثليته في دائرة مفرغة من رؤية مشوهة للعالم، تغذي ذلك الاختلاف وترسخ من تلك الرؤية المنقوصة.
«إدمان» المتعة؟
ويولع أكثر بالبوظة والمخدرات، ويتمادى في ممارسة شذوذه حتى خرج به من السر إلى العلانية… وأطلق وحيد على نفسه «صاحب الرؤيا» ولكن الحرافيش دعوه سراً بالأعور. وعرف بشذوذه فلم يتزوج، وأحاط نفسه بفتية مثل المماليك.
نجيب محفوظ، الحرافيش؛ ص 269
إنها بحق فكرة عبقرية، تلك التي تفتق عنها ذهن محفوظ، حين ربط بين استمرارية المثلية كسلوك وإدمانِ المخدرات. فهي، من ناحية، تعطي المثلية ذلك البعد المرَضي المطلوب، ولكنها تفتح أيضاً مجالاً لبروز تفسير علمي لعدم قدرة المثلي على التخلي عن مثليته، أو لتشبثه بهذا السلوك.
فبجانب التوصيف الديني للمثلية كـ«ابتلاء» (كما يصفها السيد رضوان في «زقاق المدق»)، يتجاوز محفوظ الخطاب الديني المعتاد مرة أخرى ويُسبغ على تصوره صبغة حداثية بامتياز، لتصبح المثلية ليست مجرد ابتلاء ولكن عرضاً مرضياً، له بعد سلوكي مدمر.
ثانياً، تشبيه المثلية بالمخدرات يعطيها ذلك الجانب الوبائي الذي دائماً ما يرتبط بالمخدرات، وكأن المثلية نوع من المخدرات إذا جربه الشخص أدمنه وتمكن منه. وثالثاً، مثلها مثل المخدرات، فإن تأثير المثلية تصاعدي، يؤدي إلى هلاك المثلي في آخر الأمر (مثل الفتوة وحيد في ملحمة الحرافيش، «ومات إثر هبوط في القلب نتيجة الإفراط في البلبعة»، ص 319).
ومثل تصورات محفوظ الأخرى، ما زال مثقفو النظام والدولة أسرى لتلك التصورات، إذ كتب فاروق جويدة في الأهرام، في 26 سبتمبر 2017، عمود رأي بعنوان «احتفالية الشواذ» بعد واقعة رفع علم الرينبو، ليقارن مرة أخرى بين المثلية والمخدرات ويطالب الدولة ومؤسساتها بالتدخّل لإنقاذ المجتمع المصري من ذلك «الوباء».وبالتوازي، لا يسعنا بعد قراءة محاضر الداخلية ومذكرات النيابة عن «تهمة اعتياد الفجور» وما يتبع ذلك من لغة تتماثل مع لغة توصيف المواد المخدرة أو المخدرات، إلا أن نرى صدى لتصورات محفوظ والتطبيق القانوني/العقابي لفكرة الإدمان، التي تتطلب تدخل السلطة ليس فقط للإصلاح والتأهيل، ولكن للسيطرة على تلك الأجساد التي تشبع رغباتها خارج المجال القانوني/القيمي للدولة/المجتمع والتنكيل بها.
ذلك المصطلح المبهم: «فطرة»
ومن عجيب أن المعلم كرشة قد عاش عمره في أحضان الحياة الشاذة، حتى خال لطول تمرغه في ترابها أنها الحياة الطبيعية. هو تاجر مخدرات اعتاد العمل تحت جنح الظلام وهو طريد الحياة الطبيعية وفريسة الشذوذ. واستسلامه لشهواته لا حد له ولا ندم عليه ولا توبة تنتظر منه.
نجيب محفوظ، زقاق المدق؛ ص 50
استكمالاً لفكرة الإدمان وما يتبعها من سلب الإرادة أو سحقها، فمن المنطقي أن المثلية، مثلها مثل المخدرات وإدمانها، تغيّر «طبيعة» الشخص أو «فطرته السوية». واستخدام مصطلح فطرة هنا يحقق هدفين رئيسين، فهو، من ناحية، يستدعي المعنى الحيوي-الأخلاقي، لأن «الفطرة» لغة هي الخلقة، أو الحالة الأولى التي يوجد عليها الإنسان، وهي بالتالي الحالة الأصلية «السليمة»، وهي بديهية، يعرفها الجميع ولا تحتاج إلى شرح أو تفسير. ومن ناحية ثانية، يعمق استخدام مصطلح «فطرة» من «انحراف» المثلية عن تلك الحالة الأولية السليمة، لأنه إذا كانت الفطرة واضحة، لا تحتاج إلى شرح أو تفسير، فإن أي سلوك لا يتماشى معاها يتطلب ليس فقط التبرير، ولكن التقويم والإصلاح كذلك.
يصبح إفساد تلك «الفطرة»-بوصفها شيئاً هشاً، من السهل التلاعب به أو إفقاده براءته- الشغل الشاغل لمحفوظ في كثير من روايته (فكرة استغلها محفوظ أيضاً في التنكيل بالنساء، فاستخدم الأمومة كفطرة أو حالة أولية ورئيسية لنسائه، وكل من حادت عن تلك الفطرة لم يرحمها محفوظ، هي «عاهرة»، «شرسة»، أو «وقحة»… إلخ). وتكون المثلية هي السلوك أو الانحراف الذي يودي بالفطرة إلى غير رجعة، فيتشوّه الشخص المثلي ويفقد إنسانيته، ويصبح «شذوذه» بديلاً عن «الفطرة السوية».
واعتلال الفطرة أو تشوهها هي ثيمة مكررة عند كثير من الأدباء المصريين، ونجد مثالاً على ذلك عند جمال الغيطاني (وهو أكثر أبناء جيله تأثراً بمحفوظ من حيث الأسلوب والموضوع) في وقائع حارة الزعفراني (1976)، عندما جعل الغيطاني من «عويس»، الصعيدي القادم إلى القاهرة، «فحل» الحمام، يعتاد ممارسة الجنس مع نزلاء الحمام من الرجال «حتى أصبح الأمر عادة» ولم يعد قادراً على «معاشرة» النساءلم يذهب، باستطاعته التغيب عن الحمام ساعة أو ساعتين لكنه لم يمضي إليها، وعندما تمدد في حجرته ثنى ثوبه عدة مرات تحت رأسه ليستخدمه كوسادة، شيء ما قبض صدره، منعه من التفكير في أم يوسف، لم تأخذه نشوة، هل يعجزه عمله عن معاشرة النساء؟ خاف، هل ينقلب حاله بعد حين فيصبح كأحد زبائنه. وقائع حارة الزعفراني، ص 40.، كعلامة واضحة على فساد فطرته وتمكن «الشذوذ» منه.
لا حل غير الإبادة
إنه رجل فاجر لا يرده عن شهوة لا سن ولا زوجة ولا أبناء. ولعلك علمت بأمر هذا الشاب الرقيع الذي يوافيه كل ليلة إلى القهوة؟! هذه هي فضيحتنا الجديدة… ولكني إذا يئست من إصلاحه فسأشب النار في الزقاق جميعاً وأجعل من جسده النجس حطاما لها!
نجيب محفوظ، زقاق المدق؛ ص 100
ليس هناك أي مواربة في الخيالات الدموية لأم حسين، زوجة المعلم كرشة، التي لم تتوان عن إطلاق جماح خيالها في تصور أشد وأفظع أنواع العقاب لزوجها «الشاذ»، بل أنها ذهبت إلى حدّ إحراق الزقاق بأكمله كعقاب على سكوته وتواطئه مع فجور زوجها وشذوذه.
ورغم أن أم حسين لم تضرم النار في الزقاق كما هددت، إلا أنها أدت مشهداً لا يضاهيه أي مشهد آخر ربما في تاريخ الرواية العربية الحديثة، في دراميته أو سخريته.
وصرخت بصوت كادت أن تتصدع له أركان القهوة: يا حشاش، يا مدهول، يا وسخ، يا ابن الستين، يا أبا الخمسة، وجد العشرين، يا عرة، يا رطل، سفخص على وجهك الأسود فحدجها المعلم بنظرة قاسية وهو منتفض من الانفعال. وصاح بها: لمي لسانك يا مرة، وسدي هذا المرحاض الذي يقذفنا بوسخه! قطع لسانك ما مرحاض إلا أنت، يا خرع، يا مفضوح، يا ظل العيال…
نجيب محفوظ، زقاق المدق؛ ص 100
في النهاية، في سابقة فريدة من نوعها، لم يقتل محفوظ المعلم كرشة، واكتفى أن يرينا أنه لا أمل في فجور الرجل (فحتى آخر الكتاب نراه يحاول استمالة أخو امرأة ابنه وغوايته)، تاركاً لنا رغبات أم حسين الانتقامية كامتداد لرغباتنا نحن كقراء، فلا شك أنه عندما «نرى» المعلم كرشة يتبادر إلى ذهننا هوس الإبادة لمثل هذا «الشر القديم».
لم يتفرد محفوظ بالخيالات الدموية، من الحرق إلى القتل، إذ يكتب علاء الأسواني مشهداً، فيه من البشاعة والدموية ما يقابل خيالات محفوظ:
ظل عبده واقفاً في وسط الحجرة حتى استجمع الأمر في ذهنه، ثم أصدر صوتا غليظاً أشبه بحشرجة حيوان متوحش غاضب، وانقضّ على حاتم يركله ويلكمه بيديه وقدميه، ثم أمسك به من رقبته وأخذ يضرب رأسه في الجدار بكل قوته حتى أحس بدمه ينبثق حاراً لزجاً على يديه.
علاء الأسواني، عمارة يعقوبيان؛ ص 334
تفتقد لغة وأسلوب الأسواني جزالة وتعقيد محفوظ بلا شك، وتصوير ذلك المشهد يبدو أشبه بالكتابة التليفزيونية والسينمائية عنها بالكتابة الأدبية. ولعل ذلك يزيد من فجاجة المشهد وقبحه. وقع الأسواني في فخ تقديم شخصية مثلية، وحاول أن يكون في تصويرها شيء من التوازن، إذا كان هذا ممكناً مع كل هذا الرُهاب والوصم الأخلاقي. وقع الأسواني في فخ تقديم شخصية مثلية، وحاول أن يكون في تصويرها شيء من التوازن، إذا كان هذا ممكناً مع كل هذا الرُهاب والوصم الأخلاقي. كما حاولَ أن يخلق علاقة مثلية تكاد تكون لها استمرارية تتجاوز الدعارة الصريحة (لكن لا تخلو من الاستغلال الطبقي؛ التلاعب بنفسية من هم أقل سناً وخبرةً وتعليماً؛ الهوس العنصري بشكل وطبيعة جسد ما بشكل استشراقي فج… إلخ)
ولكن لأن حتمية الإبادة تفوق أي اعتبار آخر، كان لزاماً عليه أن يقتل الشخصية المثلية بأقصى درجات العنف والانتقام، حتى لا يعتقد القارىء أن الأسواني تعاطف مع شخصيته أو تخيل، ولو للحظة، أن لها مصيراً غير الموت الحتمي. يصبح مشهد الإبادة هو اعتذار الأسواني عن تصور شخصية مثلية من الممكن للبعض منا التعاطف معها، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح: الإبادة ولا بديل عنها.
ألا للخلاص من سبيل؟
فضحك حلمي عزت قائلاً: إنك يا باشا مؤمن، وإن إيمانك لما يحير الكثيرين!
لمه؟ إن الإيمان واسع الصدر، والمنافق وحده الذي يدعي البراءة المطلقة، ومن الغباء أن تظن أن الإنسان لا يقترف الذنوب إلا على جثة الإيمان، ثم إن ذنوبنا أشبه بالعبث الصبياني البرىء!
نجيب محفوظ، السكرية؛ ص 146
تجرأ محفوظ في السكرية (1957) وفعل شيئاً لم يفعله من قبل: أعطى شخصياته المثلية مساحة من التساؤل والشك حول موقعهم داخل مجتمعهم، ولم يصاحب ذلك أي تداعٍ أخلاقي مشين (مخدرات، كحول، دعارة… إلخ)، ولا تصورات دموية عن هلاكهم وقتلهم بصورة بشعة ومؤلمة كما هو شائع. بل ذهب محفوظ لأبعد من ذلك وجعل شخصياته المثلية تتكلم عن طبيعة الإيمان، الثواب والعقاب، الأخلاق… إلخ.
الأسواني كذلك
«لو أنه يؤمن بالله لاعتقد أن محنته عقاب إلهي على اللواط، لكنه يعرف عشرة لوطيين على الأقل يهنأون بحياة وادعة مطمئنة مع عشاقهم، فلماذا هو بالذات يضيع منه عبده؟!»
عمارة يعوبيان، ص 315
وقبل أن نثب من الفرحة ونشد على يد محفوظ، فإن مثل تلك المساحة لا تعني أن موقف محفوظ قد تغيّر، أو أنه بات مقتنعاً أنه من غير الممكن نزع إنسانيّة المثليين من أجل هواجس أخلاقية ساذجة، بل على العكس: ما فعله محفوظ هو أنه حال ما أعطى لشخصياته المثلية مساحة للتساؤل والشك، أظهر لنا مدى تعاسة ويأس مسارات تلك الشخصيات كنتيجة مباشرة لمثليتهم، وأسباب «نجاح» بعضها ترجع إلى «التزامها الزائد بالأخلاق» في كل نواحي حياتها، ما عدا «مثليتها» بالطبع.
فحتى الشخصيات التي كتب لها النجاح العملي على الأقل، مثل شخصية عبد الرحيم باشا عيسى، لم تسلم من شبح الوحدة والتعاسة، فجعله يقول: «لأن يوم الأعزب طويل كليل الشتاء، ولابد للإنسان من رفيق، وإني لأعترف بأن المرأة ضرورة خطيرة، وكم أذكر أمي هذه الأيام! إن المرأة ضرورة حتى لمن لا يتعشقها!» (ص 146).
مرة أخرى، يسبقنا محفوظ بخطوة ويشير إلى الاختيارات التي قد يقوم بها بعض المثليين لمحاربة شبح الوحدة، كما يصفها هو، ولكنها -بالأحرى- اختيارات للهروب من وطأة الضغط المجتمعي للتماهي مع ما هو متوقع ومقبول. يرى محفوظ أنه لا بديل عن حاجة الفرد إلى الرفيق والأنس من الوحدة. ويكشف لنا محفوظ العُقد العديدة التي تفرض صعوبة، أو بمعنى أدق، استحالة تكوين علاقات مثلية مستدامة، توفر ما توفره العلاقات الغيرية من استقرار نفسي ومعنوي، في مجتمع مثل مجتمعنا.
إن مثل تلك النظرة النفعية للنساء تزيد من حالة الارتباك والخلل الذي يتخلل علاقة المثليين بسياقهم الاجتماعي الأوسع. يُشرّح محفوظ الأزمة بدقة، ولكنه يعيدنا مرة أخرى، بطريقة غير مباشرة، إلى جدل الفطرة وثمن الاختلاف.
فتح الخزانة وحتمية الإفصاح
وإذ تعلن الحركة تضامنها مع الحق في التنوُّع والاختلاف، فإنها تؤكِّد على دفاعها عن الحق في التحرُّر من النبذ والاضطهاد والملاحقة، والحرية في الإعلان عن هذا التنوُّع. وتُشدِّد الحركة على أن الحريات لا تتجزَّأ والنضال من أجل التحرُّر الاجتماعي والسياسي الشامل لا يمكن أن يكون إلا بمقاومة كافة أشكال الاضطهاد والنبذ والتشويه والدفاع عن كل المُضطهَدين بسبب الجنس أو الميول الجنسية أو العرق أو اللون أو الدين.
بيان حركة الاشتراكيين الثوريين، 26 سبتمبر 2017
باستثناء بيان الاشتراكيين الثوريين هذا، تَسيّدَ المشهدَ المصري أثناء الحملة الأمنية على المثليين خلال قضية «علم الرينبو» -رغم الوصم والتحريض والسجن والاعتقال- الصمتُ التام. لم يستنكر أحد من مجموعات اليسار أو التقدميين ما قامت به الحكومة المصرية من تنكيل وملاحقة وتصيّد للمثليين والمتحولات جنسياً على خلفية قضية «علم الرينبو»باستثناء الخطاب الحقوقي ومنظمات حقوق الإنسان، نادراً ما انخرط سياسيون منتمين إلى تيارات سياسية يسارية أو تقدمية في الدفاع عن المثليين أو مجتمع الميم بشكل واضح، أو تم دمج نضال مجتمع الميم كجزء من نضال اليسار أو القوى الثورية.. لم تكن هذه المرة الأولى التي تتخاذل فيها التيارات التقدمية واليسارية عن إبداء التضامن الواجب والمستحق لمجتمع الميم، ولكن ما كشفه هذا الصمت الأخير كان أن حسابات هؤلاء السياسية، ورغبتهم في الحفاظ على ما تبقى من «قواعد اجتماعية محافظة» تتركنا وحدنا في معركة البقاء أو الوجود. يكفي قراءة بعض من تعليقات أعضاء صفحة الاشتراكيين الثوريين على فيسبوك، لمعرفة التكلفة السياسية التي قد يتضمنها الاعتراف بنضال مجتمع الميم ضمن نضال أوسع وأشمل، يمثل نضال الجميع من أجل الحرية والعدالة.
إن تخاذل اليسار والتيارات التقدمية، وفشلهم في تعريف «أولويات النضال»، يدفعنا إلى مُساءلة معنى هذا النضال وما يمثله أصلاً كمشروع سياسي تحرري، فإن لم تشمل أولويات النضال حرية الجميع في أجسادهم/ن، وحرية الاختيارات الحميمية بين بالغين فيما تراضوه بينهم/ن، وتفكيك سلطة الدولة من على أجساد ونفوس العباد… إن لم يكن هذا هو جوهر وأصل النضال، فما هو النضال إذن؟
إن ما توارثه اليسار منذ بدايات حركات التحرر الوطني ودولة الاستقلال من تهميش لقضايا النساء، والأقليات الدينية، ومجتمع الميم، وتأميم هذه القضايا في شكل «عطايا الدولة»، يعيدنا من جديد إلى تلك اللحظة ذاتها: «هي شر قديم… وليست بالحب».
بين محاولة خلق مساحة من التضامن تتجاوز محدودية تعريف المثلية، وبين محاولة تبرير تلك الاختيارات على أساس الهوية/المجموعة المضطهدة، تضيع قضية محورية عامة: أن الحرية والعدالة والمساواة لا تتجزأ، ولا يمكن نبذها كقيم تنويرية غربية لا تمت لواقعنا بصلة.
تلك الخزانة كمساحة مشهدية -يرانا الغيريون، ولا نراهم (لعوار رؤيتنا، لنقصها، لتشوّهِها)- الخزانة كمساحة تكتم السر، تحفظ ذلك الشر القديم، الخزانة كتراكم لكل هذه الإسقاطات البغيضة المسمومة، تلك الخزانة قد ضجّت بكل ما تحتويه من الأسرار والشرور. لا نستطيع الانتظار، ونعلم حتمية الإبادة وندرك أن الثمن فادح، ولهذا يجب علينا فتح الخزانة والإفصاح عن كل ما أخفاه الزمن والبشر، لأنه لا سبيل للخلاص دون الحقيقة، وإذا كان الموت آتٍ آت، وإذا لم نتكلم الآن، متى نتكلّم؟
الهوامش
[1] الترجمة الشائعة لـ LGBT+ هي «مجتمع الميم»، والتي تشير إلى حرف الميم في: مثليين/ات، مزدوجي/ات الجنس، متحولين/ات جنسياً وكل أطياف مختلفي الجنسانية
[2] تزايدت الملاحقات الأمنية وحالات القبض على المثليين والمتحولات جنسيا (الترانس) منذ 2013 بشكل متزايد حتى سبتمبر 2017، حيث وصلت إلى أكبر عدد من الحالات التي تم القبض عليها واتهامها بـ «اعتياد ممارسة الفجور»، وهي الجريمة التي عادة ما يُعاقب المنتمون لمجتمع الميم وفقها طبقاً للقانون المصري
[3] لا يجرّم القانون المصري المثلية بشكل واضح، وتُعتبر مصر حالة فريدة في السياق العربي/الإسلامي. ما يتم محاكمة المثليين أو المتحولات جنسياً (الترانس) به عادة هو مواد لقانون رقم 10 لسنة 1961 مكافحة الدعارة
[4] اختيار «خزانة» كترجمة لـ closet قد يبدو للوهلة الأولى ترجمة حرفية مباشرة. لكن الـ «خَزن» يعني كتمان الشيء أو حفظه في مكان ما. وتلك السرية، مُضافةً للإخفاء، هي جوهر مصطلح closet وما يستدعيه من مساحة خاصة، غير مرئية، يخفي فيها الإنسان شيئاً ما
[5] رغم انخراط سدجويك في العمل السياسي والنسوي منذ التحاقها بالجامعة في 1967، إلا أنها لم تكتب أو تنظّر عن العمل السياسي بشكل مباشر، ولم تتمحور كتاباتها حول مشروع سياسي واضح، إذ تركزت معظم أعمالها حول الأدب والنقد بشكل كبير
[6] نتيجةً لعوامل مركبة ومعقدة عديدة، لم ينتشر مرض متلازمة المناعة بالشكل الوبائي نفسه في معظم العالم العربي مثلما حدث في الولايات المتحدة في الثمانينات. غياب «سردية الوباء» لا يعني أنه لم أو لا توجد حالات إصابة، بل العكس: المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة تقريباً التي ما زالت تشهد ازدياداً في نسب الإصابة بالمرض حالياً
[7] لاشك أنه لدى نظام يوليو تاريخ طويل وحافل في التنكيل بالفصائل السياسية المعارضة، من الشيوعيين واليسار إلى الإخوان المسلميين وأتباعهم. لكن الملاحقة الأمنية لمعارض سياسي لا تتساوى إطلاقاً مع التنكيل بإنسان نتيجة لاختيارات/ها الجنسية والحميمية
[8] بإجماع أغلب المذاهب فإنه ليس لـ«السحاق» حدّ، ولكن يستوجب التعزير حسب ما يقدّره القاضي، وغالباً ما تواتر في الفقه الإسلامي أن «علاج السحاق» هو تزويج النساء وضمان توفير الأزواج الصالحين من الرجال
[9] على سبيل المثال لا الحصر: كتابات سيمون دي بوفوار الجنس الآخر، 1949؛ كايت ميليت السياسات الجنسية، 1971؛ كريستيان دلفي، استغلال حميمي، 1992
[10] بالمقارنة بالتراث اليهودي-المسيحي، نجد أن الأوقع أن الفعل يُنسب إلى أصحابه، فـ «لواط» كانت دائما ما يشار إليها بلفظ «سدومية»، نسبةً إلى المكان وليس الشخص
[11] ذُكر قوم لوط في القرآن في ثمانية مواضع مختلفة: في سور الأعراف، هود، الحجر، الأنبياء، الشعراء، النمل، العنكبوت، القمر. ولا يكاد يخلو موضع ذكر دون إدانة أو استنكار لأفعالهم
[12] هناك جدل في المباحث الفقهية عن صحة ما ورد عن النبي والصحابة في حكم اللواط (فتم استبعاد أغلب الأحاديث، على سبيل المثال، لضعف إسنادها). ولكن إجماع الفقهاء وأهل الرأي على تجريم الفعل، وخاصة الفقهاء اللاحقين، يكاد يتجاوز أي مُساءلة حقيقية لأدلة تحديد العقاب